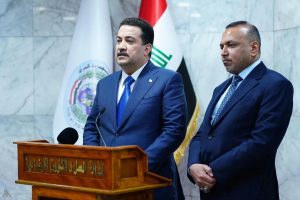باسم فرات لـ”العرب”: الشعر هويتي الأولى والترحال مكتبتي التي لا تحدها الجدران
يُعد باسم فرات واحدا من أبرز الوجوه الثقافية العراقية التي استطاعت المزاوجة بين عمق التجربة الشعرية واتساع الأفق الرحلي. في حواره مع “العرب”، يتحدث فرات عن طفولته الشاقة، واضطراره للمنفى، وتجربته الفريدة في صياغة نص رحلي يرفض المركزية ويحتفي بالتنوع الإنساني، مؤكدا أن العمارة الحقيقية ليست في الحجر، بل في سجل تاريخي حي يكتبه المبدع.
باسم فرات شاعرٌ، رحالة، وكاتب عراقي، أطلق الاحتجاج الأول سنة 1967، أما احتجاجه الثاني فقد كان قصيدته الأولى وهو في المدرسة لا يزال، سنة 1978، ثائرا على طفولة شاقة وبائسة، بعدما رحل الأب وترك باسم الطفل يواجه العالم لوحده، مرة يعمل مصورا فوتوغرافيا ومرة صانع تحف، ومرة صانع عيش الحياة. منذ أن غادر العراق صوب عَمان في العام 1993، وهو يخيط شراك الأرض جنوبا وشمالا، شرقا وغربا، حيث عاش بعدها في نيوزيلاندا، أستراليا، اليابان، الإكوادور والسودان.
عاشقا للرحلة، شاعرا بالفطرة، خلّف باسم مجموعة من الأعمال في الشعر (أشد الهديل، خريف المآذن، بلوغ النهر، أشهق بأسلافي وأبتسم). في السيرة والرحلات (مرح في الأساطير، الحلم البوليفاري، طريق الآلهة، أماكن تلوح للغريب، لا عشبة عند ماهوتا، اغتيال الهوية)، وهو يقيم الآن في نيوزيلاندا متفرغا للكتابة الأدبية والإبداع الفني.
جمعنا به حوار لصحيفة “العرب”، اخترنا أن نبدأه بسؤال إلى أي حد له من اسمه نصيب؟ أجاب “حتى الآن، يمكنني القول إنني عشت التناقضات، وأعتقد هذه طبيعة الحياة الثرية بتفاصيلها، من يُتم وحرمان، وعمل شاق في عمر السابعة، إلى هوس بالشعر والكتب والمعرفة، ومحاولات الإسهام في صناعة الجمال، إلى تأبط كتب التاريخ، والترحال عبر الأمكنة والثقافات والعقائد. نعم أنا سعيد جدًّا، وحزينٌ جدًّا، مُقبل على الحياة شعرًا، وكتابةً، وقراءة، وسفرًا، ولعلني أحاول بترحالي وتنقلي بين الشعر وأدب الرحلات، والبحث في الهُويّة، أن أُعوّض ما جرى لي في طفولتي، ومراحلي العمرية التالية، من خسارات كبيرة”.
شاعر قارئ
باسم هو شاعر ورحالة وكاتب سيرة وصحفي ومنشغل بالحوار الثقافي والحضاري مع الآخر، لكنه من بين كل هذه التلوينات، يصنف نفسه “شاعرا، لأن الشعر هو الذي قادني للقراءة والبحث والمغامرة والترحال، وكل ما عملته في حياتي قراءةً، وترحالًا، وبحثا مضنيا، سببه ودافعه الشعر. كل هذا كي أستطيع أن أتهجى الشعر، أن ألثغ به. لكنني أعترف، بأن صفة قارئ، أجدها أكثر إغراءً لنفسي. أن تكون قارئًا، يعني أنك الشخص المحظوظ الذي كتب لك ومن أجلك الشعراء والكُتّابَ والمؤلفون كافة. الشعر أعلى مراحل الجمال، ومحفز كبير على الـمعرفة، الشعر هو ابن الهُويّة البار.
نشأ محدثنا في العراق، البلد المثقل بإرث حضاري وشعري كبير، بلدٌ ينبت فيه الشعر في كل مكان، بلد المتنبي وأبي نواس، وأبي تمام، والجواهري والرصافي ونازك الملائكة والسياب، عن تأثيره على نشأته الإبداعية، يقول “العراق، بلد مثقل بإرث حضاري وشعري كبير بل عظيم، وهذا ما يَترك أثره الكبير على كل عراقيّ، بل ثمة حالة في الـمجتمع العراقي، ألا وهي تقديم صفة الشاعر على أي صفة أخرى، فالشاعر العراقيّ، حتى لو أجاد في مجالات جمالية ومعرفية أخرى، يُفَضل أن ينادى بالشاعر، وليس بسواه”.
ويتابع “كنتُ في الثامنة من عمري، حين كنتُ أعمل في محلّ حَذّاءٍ، كان صديقًا للراحل أبي، وكنت أجلب له الجريدة يوميًّا، وحين كان يقرأ القصائد الـمنشورة في الصحيفة، أشعر بالكلمات تلامس روحي، علمًا، أن حداثة سني لا تسمح لي بفهم أغلب القصائد التي كان يتلوها، أو يتلوها أحد أصدقائه الذين كانوا يترددون بكثرة على مكان العمل”.
ويضيف أنه “منذ ذلك الوقت، اجتاحني حب الشعر، وقررتُ أن أكون شاعرًا، وفي العاشرة من عمري، ذهبت لابن عمتي وأخي في الرضاعة، وكان يكبرني بأربع سنوات، وكان شاعرًا، كذلك شقيقه الأكبر، وقلتُ له بالحرف الواحد: أُريد أَن أصبح شاعرًا. من هنا بدأ مشواري الشعريّ، وكنتُ أمينًا على نصيحته، بأن أقرأ لكل ما يتيسر لي من شعر، وبدأت بشعر ما قبل الإسلام، ثم تدرّجت بالعصور الشعرية، حتى قرأت شعراء الحداثة، وما تيسر لي من شعر مترجم، هذا قبل تعلمي للغة الإنجليزية”.
في إحدى قصائده قال “لا أحد يغرد في حنجرتي” وكرر القول نفسه في معرض إحيائه لذكرى وفاة بدر شاكر السياب. سألناه إلى أَيِّ حَدٍّ تأثر بالسياب وإلى أي حد تخلص من أولئك الذين فتنوه في مرحلة من المراحل سواء أكانوا شعراء عربا أم غربيين؟ فأجاب “منذ طفولتي، حين قررتُ أن أصبح شاعرًا، وأنا في العاشرة من عمري، انتبهتُ إلى أن لكل شاعر لغته، وأسلوبه، مثلما ضايقني التكرار في مطالع بعض القصائد منذ عصر ما قبل الإسلام، أو ما يُطلق عليه العصـر الجاهلي، ضايقني أيضًا، الإسفاف عند كثير من الشعراء، وكذلك التقليد. لا أفهم كيف لشاعر يُقلّد شاعرًا آخر، ولا يكتب ذاته، لأن لكل إنسان بصمته، كما هي بصمة الأصابع التي لا تتشابه من إنسان إلى آخر، كذلك حياة وذكريات وتجارب ووعي ومستوى التّلقّي من إنسان إلى آخر تختلف”.
وأكد “تأثرت بالسياب نعم، ولكن لم أُقلّده، لأن التقليد، مسخ لذات الـمُقَلِّد، بل حتى إعجابي بشعر سعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر وسركَون بولص ويوسف الصائغ وشعراء عراقيين وعرب آخرين، لم يصل للوقوع في دائرة التقليد، فنجت نصوصي من أن تَكون مسخًا عن آخرين، وقد أشار أكثر من ناقد وشاعر ممن قرأوا شعري، إلى خصوصيتي في كتابة القصيدة. هذه الخصوصية، هي الـخطوة الأولى في طريق الإبداع والـمشروع الشعري”.
وتطرق فرات إلى مغادرته العراق، كيف حدث ذلك؟ وهل يمكن أن نقول عن منفاه إنه منفى اضطراري؟ فقال “قَرَأتُ الـمشهد العام، بعد كارثة اجتياح الكويت، فوصلتُ إلى يقينٍ، أن بقائي في العراق، هو خراب لحياتي، بل تحطيم حقيقي، صرتُ أستحضر كل الـمعدومين والـمُغَيَّبين من أهلي وأقاربي ومعارفي، وصار شعور خفيٌّ يتسلل إلى أعماقي، أن مصيري، لا يختلف، وما يفصلني عنهم، مجرّد أيام، أَأنتظر أن يكون مصيري هو نفسه مصير ابنَي عمتي وأَخَوَيَّ بالرضاعة، وأبناء عمومتي وخؤولتي أم أغادر العراق بلا رجعة، وأتحمل عواقب الـمنفى وجوعه وبرده، وسلبياته كلها؟”.
واستدرك “لكن الـمنفى، له سطوته، وسنواته الآن تقترب من ثلث القَرن، زرت العراق مرارًا، وكانت أول زيارة لي، بعد غياب متواصل استمر ما بين الثالث والعشرين من نيسان – أبريل 1993 إلى الثامن عشر من أيّار 2011 للـميلاد، أي أكثر من ثماني عشرة سنة. ما يفرحني حقًّا، في كل زيارة للعراق أرى تطورًا، لاسيما الفروقات الكبيرة، ما بين أول زيارة، أي في عام 2011 وبين آخر زيارة أي في عام 2024 للميلاد. لكنني أبقى موجوعًا، باضطراري لاستعمال كلمة زيارة لوطني، راجيًا أن أستطيع مستقبلًا من الانتقال الدائم للعيش في العراق، وأن يتحقق حلمي بالإقامة في بغداد”.
مشروع جمالي
عن كيف يرى أدب الرحلة المعاصر إذا ما قارنّاه بالموروث الرحلي القديم. رحلات ابن فضلان وابن جبير وابن بطوطة على سبيل المثال؟ يقول فرات إنه “أمام وسائل التواصل الاجتماعي، وثورة الاتصالات، لم يعد أدب الرحلات مثلما كان عليه في زمن الرواد الأفذاذ، الذين ذكرتهم في سؤالك. في حاضرنا، يعتمد أدب الرحلة عندنا على قراءة الـمكان، والاستفادة من كمية المعلومات الهائلة عن البلد الذي نكتب عنه، من أجل إبداء رأيٍ له خصوصيته، تاريخيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، مع مقارنات بينه وبين ثقافتنا العربية الإسلامية، وثقافات أخرى، وهذه الـمقارنات، تخلو من أفعال التفضيل، وممارسة سلطة مركزية. أدب الرحلات، من أكثر الآداب، تتضح فيه شخصية الكاتب، وثقافته ووعيه”.
أما عن تصوره للشعر، وهو الذي لا شك تعرف على آداب العديد من الأمم، وعاين أشكالًا إبداعية متنوعة ومختلفة، كالهايكو الياباني مثلًا أو قصيدة النثر الغربية، وكيف ساهم هذا في تكوين مفهوم الكتابة الشعرية لديه؟ فقال إن “الشعر، مشروع جمالي بحت. يستحق أن يُكرّس الشاعر حياته له، ولأنه أعلى فنون التعبير عند الإنسان، بل هو الـهُوية الأقرب للجماعة الثقافية، أو بعبارة أخرى، هو الـممثل الأقرب للهُوية، فبإمكان كثير من الناس تأليف كتب بلغة ثانية، إلّا الشعر، لا يتم إلّا باللغة الأولى، وقد أوضحت في كتابي ‘اغتيال الـهُوية’ الفرق بين مصطلحَي ‘اللغة الأولى’ و’اللغة الأمّ’، إذ إن اللغة الأولى من الممكن أن تكون هي نفسها اللغة الأم، وممكن غيرها، مثال ذلك، أن سركَون بولص كانت لغته الأم ‘السّريانية’، في حين لغته الأولى العربية”.
كما يعتبر أن “القراءات تُوسع مدارك الإنسان، فضلًا عن الترحال والاحتكاك بثقافات مختلفة؛ كل هذا وغيره أسهم في تشكيل أو قل تطوير مفهوم الكتابة الشعرية لديّ. لكن هذا الكلام لا يُلغي حقيقة أَنّ كلَّ تعريف تحديد وتحجيم، والشِّعرُ عصيّ على التعريف، لأنه جامح، وتكوين مفهوم للكتابة الشعرية، لا يتعدى أكثر من محاولة، وكل محاولة نسبة الفشل فيها تقترب من النصف”.
تعرف باسم فرات على العديد من ثقافات العالم وخصائصها. سألناه هل يمكن أن نقول إنه رضي من الغنيمة بالإياب؟ ثم ماذا أعطاه السفر وماذا أخذ منه في المقابل؟ فأوضح أن “الترحال منحني الكثير، والسبب، أنني لم أعش على هامش المجتمعات التي أقمت بين ظهرانيها، بل كنت وما زلت، أحفر في هذه الـمجتمعات لمعرفة أكبر وأعمق، يمكنني الزعم ببعض الجرأة: أن ترحالي عبارة عن مكتبة لا تحدها جدران اللغة والعقائد والتقاليد، انفتاح تام على الشعوب الأخرى، والانغماس بطبقاتها العميقة، لم ألامس السطح في أي مجتمع أقمتُ فيه، بل حتى المجتمعات التي زرتها، بذلتُ جُهدًا كبيرًا لسبر أغوارها. وهذا ما منحني ثقافة واسعة بحقول معرفية، نادرًا ما يهتمّ بها الشاعر، مثل الجغرافيا والبيئة، وأنواع الغابات، والنباتات والطيور، فضلًا عن عادات وتقاليد الـمجتمعات وعقائدها وتنوعها.
هناك اليوم قول رائج بأن هناك خطرا على اللغة العربية من أن يصبح المغربي يترجم عن السوري، والسوري يترجم عن المصري، والمصري عن العراقي وهكذا. إذا ما نحن أوغلنا في استخدام اللهجات المحلية وأهملنا اللغة العربية الفصحى التي توحد بين شعوب المنطقة”.
يرى فرات أن “القلق مشروع، بل واجب علينا جميعًا، شخصيًّا لا أفقه سببًا يجعل من الشعراء والأدباء والكُتّاب، يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي بلهجاتهم العامية، وتبقى مقولة: القرآن حفظ اللغة العربية وكذلك ارتباط الـمسلمين العميق بدينهم عبر الصلوات وقراءة القرآن والأذكار وغيرها، تخفف من غلواء الخوف على اللغة العربية. وهذا لا يمنع من دق ناقوس الخطر، والدعوة للعناية باللغة العربية، وتسهيل النحو، وتجديد تدريس اللغة العربية للتلاميذ، والإكثار من الكتب والبرامج والمسرحيات والتمثيليات والـمسلسلات الخاصة بالطفولة، ودعمها بشكل كبير، وتخصيص مبالغة كبيرة ومغرية، لتكون متاحة أمام الأطفال وأسرهم”.
تملكني فضول معرفة كيف يفصل بين الرحلي والإبداعي في شعره. وكيف يستثمر أدب الرحلة في كتابة الشعر والعكس صحيح، خصوصًا ونحن نعلم أن الخطاب الرحلي خطاب منفتح على جميع الممكنات الكتابية، فأوضح لي أن “الترحال، هو أكثر محفز لكتابة القصيدة، لأن الوقت الذي أقضيه في الرحلة، هو وقت بحث وتأمل وقراءة في المكان، بما يحويه من بشر وتاريخ وثقافات، فضلًا عن كونه وقت انبهار واندهاش. أغلب قصائدي كتبتها أو على الأقل بدأت بكتابتها، وأنا في حالة التماهي مع المكان. بعض الأمكنة، أشعر وأنا فيها، كأني في حالة انجذاب روحي، فأردد بداية القصيدة، وأدونها ثم كلما حان الوقت تزداد الكلمات، بعض القصائد تُكتب على امتداد الرحلة، وبعضها في نهاية الرحلة، وبعضها بعد العودة للبيت تكتمل القصيدة، ففي الرحلات الطويلة التي تستغرق أيامًا أو أسابيع تكتمل القصيدة في أثناء الرحلة”.
وقال “أما النص الرحليّ، فإني أُدَوّن يومياتي ليلًا، وبعد عودتي من الرحلة، تبدأ مرحلة البحث والتدوين، والتأكد من الـمعلومات، لأن كما ذكرتَ حضرتك، أن النص الرحلي خطاب منفتح على جميع الممكنات الكتابية، وأجمل ما في الخطاب الرحلي، أنك تعي حدود الخيال، مثلما تعي أهمية التحري عن صدق المعلومة التاريخية والجغرافية والاجتماعية – الإناسية الإنثروبولوجية، فضلًا عن قراءتك الخاصة للمكان التي يفرضها وعيك واهتماماتك المعرفية والجمالية”.
الشاعر الأميركي وأحد أفراد مجموعة “جيل البيت” آلان غنسبورغ اجتمع حوله بضعة أطفال صغار وأخذ يسألهم الأسئلة التالية: هل تؤمنون بالله؟ هل تمتلكون أيادي؟ هل تمتلكون أعينا؟ وكان جواب الصغار دائما هو نعم على الرغم من اختلاف ألوانهم وأشكالهم. في إشارة إلى أن الإنسان هو ذاك الواحد المتعدد، وأن الإنسان الأبيض يشبه الإنسان الأسود والآسيوي لا فرق بينه وبين الأفريقي والأوروبي، وهكذا دواليك.
أردنا معرفة رأيه هل يرى أن النزوع نحو خطاب الكونية ممكن وهو الأصل، أم أن الأمم لا تنفك تتعايش على أساس التميز والفرادة التي تطبع الواحدة منها دون الأخرى على مر التاريخ؟ فشدد على أن “الجماعات اللغوية والعقائدية، تتعايش على أساس التميز والفرادة والخصوصية، والنزوع نحن خطاب الكونية، تبناه أصحاب اللغات الـمنتصرة، مثل الإنجليزية والفرنسية وسواهما، وتم تصديره لنا، ليكون على حساب خصوصيتنا العربية الإسلامية، أصحاب اللغات الـمنتصرة، لا يخشون من ذوبان هُويتهم. معظم مَن تبنى الكونية عندنا لم يلحظوا أننا نعيش في تراجع حضاري بل انكسار كبير، فنحن مستهلكون للمنتج الغربي، ماديًّا مثل الآلات، ومعنويًّا من النظريات النقدية والفلسفة والمناهج العلمية، والمسرح والفنون وإلى آخره”.
واختتم فرات حديثه مع “العرب”، بالتطرق إلى موعد زيارته للمغرب، وهل الرحلة المغربية تدخل ضمن مخططاته الأدبية الرحلية؟ بالقول إنه “قبل جائحة كورونا، كان مشروع الانتقال للإقامة في غرب أفريقيا قد اختمر، وقررت أن أقيم عامًا آخر في السودان، كي أُكمل سبعة أعوام وارفة، لكن جرت رياح كورونا بما لا تشتهي سفني. ويبقى الحلم حتى يتحقق فتكون زيارتي لشمال وغرب أفريقيا، ضمن مشروع رحلاتي”.
حوار في صحيفة العرب اللندنية
أجراه معي الشاعر والكاتب إلياس الطريبق
الجمعة 9 كانون الثاني ” يناير” 2026 للميلاد
الصفحة التاسعة